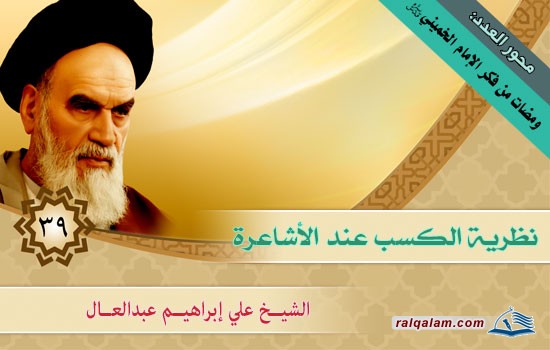
بسم الله الرحمن الرحيم، من الأبحاث الكلامية التي طرحت بين المتكلمين مسألة الجبر والاختيار وأن أفعال العباد أهي مخلوقة أم غير مخلوقة؟
هذا البحث ذو تسلسل وارتباط بغيره من المسائل كمسألة مراتب التوحيد خصوصاً التوحيد في الخالقية، ومسألة الفعل والإرادة ومسألة علم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المسائل.
غير أنّ الذي تركز عليه هذا المقالة هو نظرية الكسب التي قال بها إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري والتي تلقاها المسلمون بأشكال متباعدة فمنهم من تبناها ودافع عنها وحاول تشييد أركانها كأبي حامد
الغزالي وشارح المواقف الشريف الجرجاني والحافظ ابن عساكر وغيرهم، ومنهم من خالفها ونسبها إلى الضعف أو الجبر كأتباع أحمد بن حنبل ومنهم ابن تيمية وابن القيم.
في الواقع إن هذه النظرية ألقاها أبو الحسن الأشعري ولم يتضح مراده منها وإنما أراد الفرار من مسألة الجبر التي قد يقال: إنه تبناها عند رجوعه عن مذهب المعتزلة؛ فإن أبا الحسن الأشعري قد كان في أول حياته من أئمة المعتزلة، بل يقال إنه عكف على الاعتزال لمدة أربعين سنة من حياته أو إلى سنّ الأربعين، ولكن بعد مناظرة جرت بينه وبين أستاذه وزوج أمّه الجبائي قرر العدول عن مذهب المعتزلة وصار إلى مذهب أهل الحديث. وخلاصة هذه المناظرة أن الأشعري طرح على أستاذه مسألة وهي أن هناك إخوة ثلاثة أحدهم مات مطيعاً والآخر مات عاصياً وثالثهم مات صغيراً فما هو مصيرهم لدى الله (سبحانه وتعالى)؟ فأجابه أستاذه بأن الأول في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا في الجنة ولا في النار. فسأله الأشعري عن السبب في ذلك فقال: إنّ الأول قد أطاع واستحق الجنة والثاني عصى فاستحق النار، والثالث لم يبلغ سن التكليف لكي يستحق أحدهما. فقال: الأشعري فلو احتج الصغير على الله (سبحانه وتعالى) هلا جعلتني أكبُر فأطيعك لأدخل الجنة، فأجابه الأستاذ بأن الله يحتج عليه حينئذٍ بأنه قد سلف في علمي بأنك لو كبرت لما كنت مطيعاً بل كنت تعصيني فبحلمي ورحمتي عليك أمتك صغيراً. هنا يقنع الصغير. فعاد الأشعري وسأل الأستاذ فلو احتج العاصي على الله (سبحانه وتعالى) فيقول له: هلا أمتني صغيراً لكي لا أكبُر فأعصيك كما أمتّ أخي الصغير؟ هنا توقف الأستاذ ولم يحر جوابا.
ثم إنّ الأشعري ترك مذهب المعتزلة. والذي لا يشك فيه المؤرخون أنه صار إلى مذهب أحمد بن حنبل في بعض حياته على الأقل ولا أقل على مستوى الظاهر. ويشهد بذلك كلامه الصريح الذي لا يقبل التأويل في كتابه الإبانة الذي اتخذه جمع من أتباع أحمد بن حنبل لينسبوا أبا الحسن الأشعري إلى مذهبهم، منكرين نسبة الآراء المعروفة من مذهب الأشاعرة للأشعري أو منكرين وفاته على تلك الآراء. إن هذا الكتاب الذي وصلنا من بين مجموعة كتبه التي ضاع شطر كبير منها أثار جدلاً حول حقيقة مذهب الأشعري، غير أنك ستجد الأشعري رجلاً آخر في كتابه الآخر وهو كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. فإنّه في هذا الكتاب يسلك مسلكاً وسطاً بين المعتزلة الذين وصفوا بالمفوضة وأهل الحديث المتعبدين بالنصوص ولا يعتقدون بتأويل الأحاديث ولا بحملها على معانيها المجازية. لقد انتهج الأشعري في الإبانة منهج السلفية وأتباع أحمد بن حنبل حتى ذكر بعض الباحثين إنه ليس له شيء يميزه عن هؤلاء في كتابه الإبانة. لكن في اللمع فقد أظهر أنسا بالأدلة الكلامية التي تتفق مع منهج المعتزلة في الهيئة وإن خالفهم في الرأي والمنهج.
إن نظرية الكسب التي جاء بها الأشعري ذكرها في كتاب اللمع. ليس من المعلوم أن ما قاله الأشعري يكشف عن نظرية جديدة أتى بها في هذا المقام. من المحتمل أن ذكره لمسألة الكسب ليست إلا لإدراكه بوجود إشكال مفاده أن القول بالتوحيد في الخالقية يعني أن أفعال الإنسان كسائر المخلوقات إنما هي مخلوقة لله (سبحانه وتعالى)، وهذا يلزم منه الجبر. إن الأشعري حاول الفرار من الجبر خلافاً لما يقوله البعض من أنه أثبت الجبر، ولكنه كما سيتضح في هذه المقالة وقع فيما فرّ منه ومآل كلامه إلى الجبر أو التناقض. وعلى أيِّ حال فقد قال بالكسب وفتح الباب أمام تفسيرات كثيرة لهذا المصطلح ربما يقرب بعضها من نظرية الأمر بين الأمرين التي يقول بها الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ومع ذلك فالفجوة العميقة بين هذه التفسيرات ونظرية الأمر بين الأمرين لا تكاد تنجبر.
وقبل الخوض في تفسيرات الكسب لا بد من الإشارة إلى سبب هذا الاختلاف الكبير. وفي هذا لا بد من نقل كلام الأشعري الأساس لتتضح المسألة جلياً.
كلام الأشعري في كتاب اللمع:
قال الأشعري: "فإن قال قائل: فلِم لا دلّ وقوع الفعل الذي هو كسب على أنه لا فاعل له إلا الله كما دلّ على أنه لا خالق له إلا الله تعالى قيل له: كذلك نقول. فإن قال: فلم لا دلّ على أنه لا قادر عليه إلا الله (عزَّ وجلَّ). قيل له: لا فاعل له على حقيقته إلا الله تعالى، ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى. فإن قال: فلم لا دلّ كونه كسباً على حقيقته على أنه لا مكتسب له في الحقيقة إلا الله ؟
قيل له: الأفعال لا بد لها من فاعل على حقيقتها، لأن الفعل لا يستغني عن فاعل فإذا لم يكن فاعله على حقيقته وجب أن يكون الله تعالى هو الفاعل له على حقيقته.
وليس لا بد للفعل من مكتسب يكتسبه على حقيقته كما لا بد من فاعل يفعله على حقيقته، فيجب إذا كان الفعل كسباً كان الله تعالى هو المكتسب له على حقيقته.
ألا ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن الله تعالى هو الفاعل لها على حقيقتها ولا تدل على أن المتحرك بها في الحقيقة هو الله تعالى إذا كانت حركة كما كان هو الفعال لها في الحقيقة ولا يجب أن يكون المتحرك المضطر إليها فاعلاً لها على حقيقتها إذا كان متحركاً بها على الحقيقة إذ كان معنى المتحرك أن الحركة حلّته، ولم يكن جائزاً على ربنا تعالى"(1).
هذه بوادر الكسب طرحها الأشعري تحت عنوان (باب الكلام في القدر). فقد كان في معرض الاستدلال على كون أفعال العباد مخلوقة لله (سبحانه وتعالى) على حقيقة الأمر مستشهداً بقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}(2).
يقول الأشعري هنا كما أنه لا خالق إلا الله فكذلك لا فاعل إلا الله، ولكن ليس الأمر كذلك في الكسب فلا يجب أن يكون الكاسب هو الله وذلك لبطلان التنظير بين الفاعلية والكاسبية. إن مثل الكاسبية مثل اليد المرتعشة فإن المسبب للرعشة ليس هو الذي يرتعش. فالكسب مقول على الشيء بعد ملاحظته وليس من مقدمات وجوده ولا داخلا في حقيقته، بخلاف الخلق والفعل فإن الأحداث لا بد لها من فاعل وخالق. وبذلك يفترق الكسب عن الفعل. يلاحظ القارئ بأن هذا دليل إنّي وصفي يفسر لابدية الاتصاف وعدم الاتصاف، بغض النظر عن وجوه النظر فيه. غير أن الخلاف القائم على مدى قرون من الزمان في مسألة الكسب إنما هو في مرحلة تفسير ما هو الكسب وليس في سياق بيان لابديّة القول بالكسب. ومن هنا نشأ التباين في كلمات أعلام المذهب الأشعري، فإن الاعتقاد بأن الأشعري له تصور واضح عن معنى الكسب هو أول الكلام ولا يمكن إحرازه من خلال كلماته.
ومع ذلك فيمكن الإشارة هنا إلى كلام آخر من كتاب اللمع ربما ينهض بتفسير حقيقة الكسب التي يقصدها.
قال الأشعري: "فإن قال: فهل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته يكون كفراً باطلاً وإيماناً حسناً؟ قيل له: هذا خطأ وإنما معنى ((اكتسب الكفر)) أنه كفر بقوة محدِثه وكذلك قولنا: ((اكتسب الإيمان)). إنما معناه أنه آمن بقوة محدِثه من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته، بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين.
والقول في الكذب، وأن له فاعل يفعله على حقيقته، وكاذب به غير من فعله على حقيقته كالقول في فاعل الحركة على حقيقتها، والمتحرك بها على الحقيقة غير من فعلها على حقيقتها وقد بينا ذلك آنفاً"(3).
وقال: "فلما لم يكن هذا هكذا وكانت القدرة في إحدى الحركتين وجب أن تكون كسباً لأن حقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدِثة لافتراق الحالين في الحركتين ولأن إحداهما بمعنى الضرورة وجب أن تكون ضرورة، ولأن الأخرى بمعنى الكسب وجب أن تكون كسباً ودليل الخلق في حركة الاضطرار وحركة الاكتساب واحد فلذلك وجب إذا كانت إحداهما خلقاً أن تكون الأخرى خلقاً"(4).
ولكنك ترى أنه لم يتضح بعد المراد من الكسب من مجرد ذلك، وأن الإنية مازالت مهيمنة على الاستدلال على الكسب من غير بيان للمعنى. وعلى أيِّ حال فهذا نموذج من مقالاته في هذا الكتاب ليتضح الحال جلياً أنه لماذا كانت هذه النظرية من المبهمات الثلاث حتى قيل شعر في ذلك(5).
التوحيد في الخالقية
كما أشرنا فإن أصل القول بالكسب نشأ بعد التفات الأشعري إلى أن القول بأن الله خالق كل شيء يلزم منه إبطال الثواب والعقاب لأن أفعال العباد لا تخرج عن كل شيء وحينئذٍ فلا موجب لمحاسبة غير الفاعل. هنا اضطر إلى القول بأن الله فاعل والإنسان كاسب. ولكن هذا الاضطرار في حد ذاته غاية ما يدل عليه هو عدم التزامه بأن الله يظلم العباد فيحاسبهم على ما لم يفعلوه، ولا يعني أنه جاء بالجواب المقنع على ما وصل إليه من خلال بحثه في الآيات القرآنية من خلال كتابيه الإبانة واللمع حيث وصل إلى نتائج أكيدة بأن الله فاعل لأفعال الإنسان حقيقة.
قال في الإبانة: "وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله. ولا نستغني عن الله، ولا نقدر على الخروج من علم الله (عزَّ وجلَّ). وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما قال سبحانه: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}(6). وأن العباد لا يقدرون على أن يخلقوا شيئاً وهم يخلقون كما قال: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ}(7)، وكما قال: {لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ}(8)، وكما قال سبحانه: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ}(9)، وكما قال: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}(10)، وهذا في كتاب الله كثير" إلى أن يقول: "وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين، ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم."(11).
وهذا التحليل الأشعري في الإبانة لم يرد في اللمع ما ينفيه.
إن هذا الكلام يلزم منه نتيجة مهمة وهي إنكار مبدأ العلية والمعلولية في هذا الكون وهذا يلزم منه هدم واحد من الأسس العلمية والركائز الأساسية للفكر البشري. ليس الأشعري هو آخر من حاول المناقشة في مبدأ العلية والمعلولية أو ممن يلزم من كلامه ذلك، إلا أنّ الإشكال الأول الوارد على هذه الكيفية في إنكار ذلك هو أنه اتخذ البحث الدلالي القرآني لإنكار هذا المبدأ والحال أن هناك علية ومعلولية بين فهم النص والوصول إلى النتيجة، فليزم من إثبات البطلان بطلان النتيجة. فلما ثبت أن لا علية ولا معلولية، فليس عندنا مقدمات تؤدي إلى نتائج تنفي العلية والمعلولية، فلم يثبت لدينا انتفاؤها.
ومع ذلك وبغض النظر عن صحة استفادة هذا المعنى من الآيات الكريمة فلا يتوقف صحة الثواب والعقاب على إثبات العلية والمعلولية إذا أمكن تصحيح الكسب الأشعري، فإن المطلوب لكي يصح الثواب والعقاب هو نسبة الفعل إلى العبد بنحو من الاختيار. وهذه النظرية الأشعرية تحاول بالتحديد أن تفعل ذلك رغم اعترافها بمبدأ مهم من مبادئ الجبر وهو التوحيد في الخالقية بالمعنى المذكور. فمسألة أن الله خالق لأفعال الإنسان لا تلازم عندهم أن أفعال الإنسان لا تنسب إليه وأنه ليس مسؤولا عنها. إن الأشعرية لا يعترفون بنسبتهم القبيح إلى الله سبحانه وتعالى، رغم أن الباحثين في المذهب الأشعري من خارجه، ومنهم ابن تيمية في منهاج السنة(12)وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد(13)، ألزموهم بذلك. بل تراهم ينزهون الله عن القبيح ولا يلتزمون بلوازم التوحيد في الخالقية بالمعنى الذي فسروه. وإن شئت أن تسمي هذا تناقضاً فالأمر كذلك، وكم من ملتزم بقولٍ غير ملتزم بلوازمه. فإن المجسمة ينبغي عليهم الاعتراف بمحدودية الله (سبحانه وتعالى). وكذلك أهل الحديث الرافضون للتأويل ينبغي عليهم الالتزام بتناقض القرآن مع العقل بل مع نفسه، وبأن الدين قائم على الرمزية والإبهام، كما احتاروا في قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ}(14).
الالتزام بلوازم التوحيد في الخالقية
قبل التعرض إلى تفسير الكسب نأتي بكلام هنا للفخر الرازي في تفسيره الكبير التزم فيه ببعض لوازم التوحيد في الخالقية وهي عقيدة الجبر. قال في التفسير الكبير:
أما قوله تعالى: {لهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا}(15) ففيه مسألتان: المسألة الأولى: احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في خلق الأعمال فقالوا: لا شك في أن أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنيا، ولا شك في أنه كانت لهم أعين يبصرون بها المرئيات، وآذان يسمعون بها الكلمات، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية تقييدها بما يرجع إلى الدين، وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع إلى مصالح الدين، وما كانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين. وإذا ثبت هذا فنقول: ثبت أنه تعالى كلفهم بتحصيل الدين مع أن قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ما كانت صالحة لذلك، وهو يجري مجرى المنع عن الشيء والصد عنه مع الأمر به، وذلك هو المطلوب"
ثم الأمر الملفت هو نسبته عقيدة الجبر للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه). قال بعد أسطر:
"إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب ليس باختيار العبد، وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب، فإن الإنسان لا يمكنه مع تلك النفرة الراسخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم، وإذا ثبت هذا ثبت القول بالجبر لزوما لا محيص عنه. ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية الحسن. روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي (رضيَّ الله عنه)" عن علي بن أبي طالب (رضيَّ الله عنه) أنه خطب الناس، فقال: وأعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة وأضدادها، فإن سنح له الرجاء أولهه الطمع، وإن هاج له الطمع أهلكه الحرص، وإن أهلكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن سعد بالرضا شقي بالسخط، وإن ناله الخوف شغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع، وإن وجد مالا أطغاه الغنى، وإن عضته فاقة شغله البلاء، وإن أجهده الجوع قعد به الضعف، فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد. وأقول: هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف، وهو كالمطّلع على سر مسألة القضاء والقدر، لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب، وكل حالة من أحوال القلب فإنها مستندة إلى حالة أخرى حصلت قبلها، وإذا وقف الإنسان على هذه الحالة علم أنه لا خلاص من الاعتراف بالجبر، وذكر الشيخ الغزالي (رحمه الله) في كتاب "الإحياء" فصلاً في تقرير مذهب الجبر"(16).
والحاصل إن القول بالجبر ليس قولاً مفترى أو مستنبطاً من كلماتهم من غير دليل وحجة، بل هو إما قول صريح كهذا المنقول أو لازم الاعتقاد كما هو الحال في كلام غيره من أئمة الأشاعرة ومنهم رأس المذهب وهو أبو الحسن الأشعري كما مرّ بيانه. وهذا الإلزام الذي ألزمنا به الأشاعرة قد صرح به أيضا القاضي محب الله بن عبد الشكور البهاري صاحب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. قال في الشرح المزجي: "وعند أهل الحق، أصحاب العناية، الذين هم أهل السنّة، الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد الأكبر، له قدرة كاسبة فقط لا خالقة، لكن عند الأشعريّة من الشافعيّة ليس معنى ذلك الكسب إلاّ وجود قدرة متوهّمة يتخيّله الشخص قدرة مع الفعل بلا مدخليّة لها أصلاً في شيء، فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلاً، يخلق أوّلاً صفة يتوهّم أوّل الأمر إنّها قدرة على شيء، ثمّ يوجّه الله تعالى إلى الفعل ثمّ يوجد الفعل، فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم. قالوا: ذلك كاف في صحّة التكليف. والحقّ: أنّه كفؤ للجبر، وهو ظاهر، فإنّه متى لم يكن في العبد قدرة حقيقة، فأيّ فرق بينه وبين الجماد"(17).
الأقوال في تفسير حقيقة الكسب(18)
بحسب التقسيم الوارد في كتابي الملل والنحل والإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل فإن هناك عدة تفسيرات للكسب نتناولها تباعاً:
أ- ذكر الشيخ أن جماعة من الأشاعرة فسروا الكسب بتأثير قدرة العبد المحدِثة في الفعل. ويظهر هذا التفسير من عدة منهم الشيخ الأشعري نفسه في اللمع والتفتازاني في شرح العقائد النسفية والقاضي الباقلاني بحسب كلام الشهرستاني في الملل والنحل.
إن القدرة المكتسبة بهذا المعنى لا تعدو كونها تبريراً ناشئاً عن مسألة أن الله مستقل بخلق الأفعال وإيجادها وليست تفسيراً حقيقياً لأمر له أثر واقعي. وقد اعترف التفتازاني بذلك قال: "لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته (أي كون الله مستقلا في خلق أفعال العباد)، إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى وثبت بالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال كحركة اليد دون البعض كحركة الارتعاش، احتجنا في التفصّي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب"(19).
ب- إيجاده سبحانه الفعل مقارناً لإرادة العبد وقدرته. هذه محاولة أخرى للتوفيق بين كون الله خالقاً لأفعال العباد واستنادها إليهم، بتقريب أن قدرة الله توجد الفعل ولكن مشيئة الله لإيجاد الفعل متوقفة على مشيئة العبد، فمتى ما أراد العبد فإن الله يوجد الفعل مقارنا لإرادته. وليس للعبد أي تأثير في الإيجاد وليس الفعل فعله حقيقة ولكنه محل له كما عبر بذلك القوشجي في شرح التجريد. وبذلك صحت نسبة الفعل إلى العبد رغم أن فاعله غيره، لأن العبد أراد.
وقد يناقش هذا الكلام بأنه ما دامت قدرة العبد غير مؤثرة في الإيجاد فكيف ينسب الفعل إلى العبد ويحاسب عليه؟ قال العلامة السبحاني: "يلاحظ عليهما أن دور العبد في أفعاله على هذا التقرير ليس إلا دور المقارنة، فعند حدوث القدرة والإرادة في العبد يقوم سبحانه بخلق الفعل، ومن المعلوم أن تحقق الفعل من الله مقارنا لقدرته، لا يصحح نسبة الفعل إلى العبد. ومعه كيف يتحمل مسؤوليته إذا لم تكن لقدرة العبد تأثير في وقوعه، وعندئذ تكون الحركة الاختيارية كالحركة الجبرية"(20).
إن هذا -وإن كان واردا ولكنه- محل الخلاف بالتحديد يكمن في نقطة أخرى. إن الغزالي والقوشجي اعترفا بأن العبد ليس فاعلاً على نحو الحقيقة، ولكن لم يعلقا جواز الحساب على كونه فاعلاً حقيقة بل صرح الغزالي بأن العبد لما كان مريداً فهذه علاقة مصححة للنسبة وهذا يعني أن العبد محاسب وإن لم يكن هو الفاعل على وجه الحقيقة. من هنا يصح الدخول لمناقشة هذا التفسير، فإن المقول عليه الفاعلية لعلاقة مصححة لأن يقال عليه ذلك لا يعني أن هذه العلاقة قد صححت الحساب. فالمشكلة باقية من هذه الجهة. فلا ينفع أن نلزم الغزالي بأن العبد ليس فاعلاً حقيقة وهو يعترف بذلك، بل لا بد من مناقشته في أن ما جعله مصححا للحساب لا يعدو كونه أمراً مفترضا لا واقع له. لقد جعل الملابسة التي حاول تصويرها هي المصححة لمحاسبة الإنسان، وهذا استنتاج باطل. إن الحساب لا يترتب على غير الفاعل الحقيقي وهذه قضية وجدانية عجز هذا التفسير عن الإجابة عليها. لذلك ذكر في الإلهيات كلاماً للتفتازاني اعترف فيه بالقصور وبأنهم لم يتمكنوا من الإتيان بأزيد من هذا المقدار.
ج- نقل في الملل والنحل كلمة نقلها شارح العقيدة الطحاوية عن صاحب كتاب المسايرة وحاصل كلامه أن الدليل دل على أن أفعال العباد مخلوقة لله (سبحانه وتعالى) ولا يوجد لدينا دليل من الشارع على الاستثناء، لكن يوجد مخصص عقلي وهو أن إرادة العموم يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي. وحينئذٍ لزم القول بأن الله ليس هو الخالق للعزم على الطاعة والعصيان، فإن الخالق لهما هو العبد. وأما باقي الأفعال فهي داخلة تحت عموم ما دلّ على أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما جاء به صاحب المسايرة.
أقول كيف استقل العبد بإيجاد العزم وهل هذا إلا رجوع إلى التفويض لأن الأشاعرة -الذين يفترض أن صاحب المسايرة أحدهم- لا يثبتون منزلة بين كون الله خالقاً لأفعال الإنسان وكونها مخلوقة للإنسان نفسه وهو قول القدرية. فهل صار الشارح قدرياً في العزم وأشعرياً في الأفعال!؟
ثم إن العقل لو تم تحكيمه فهو إنما ينفي كلية أن الله خالق لأفعال العباد ولا يثبت بأن العبد لا بد من أن يخلق عزيمته. وثالثا كيف انفصل العبد عن قيمومة الله (سبحانه وتعالى) في عزمه؟ إن هذا القول إنما يرفع المشكلة بإيجاد حالة افتراضية لا دليل على تحققها في الواقع بل ولا يمكن تصورها على وجه صحيح حتى لو لم نقل بتحققها في الخارج.
د- نقل في الملل والنحل كلاماً لابن الخطيب حاصله أن العبد له قدرة تامة محدثة ولكن هذه القدرة لا أثر لها في الخارج لأن قدرة الله القديمة تتوارد مع هذه القدرة وتمنعها من التأثير. وأما الخلق فلا يصح أن يضاف إلى العبد لا لأجل عدم القدرة لدى العبد بل لأن المخلوق ما لم تتعلق به الخالقية القديمة فالعقل يحكم بعدمه لأن الإيجاد لا يكون من العدم بل لا بد من أن يكون عن مؤثر قديم غير مسبوق بالعدم.
والحاصل أن الطاعة والمعصية يصح نسبتها إلى الإنسان لأنه محل للقدرة التي خلقها الله فيه والتي بها صحت الطاعة والمعصية، لا بخلق الأفعال. وعلى أيِّ حال فهذا الكلام لا يخلو من تأمل كبير ويرد عليه بعض الإيرادات المذكورة على غيره من الأقوال. وهاهنا أقوال أخر يمكن مراجعتها في كتاب الملل والنحل.
الخلاصة:
تناولنا كلمات شتى لعلماء الأشاعرة بالنص وبالمعنى ومذهبهم في كون الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى من غير تأثير حقيقي للعبد ومحاولتهم تصحيح العقاب والثواب بمسألة الكسب. فالأشاعرة قائلون بالجبر حقيقة بمعنى أنه لا دخل للإنسان في التأثير في أفعاله، ولكن لا يصح نسبة الجبر إليهم بمعنى أنهم يلومون العبد على ما ليس له دخل فيه ألبتة، بل هم يثبتون نحواً من الملابسة بين إرادة الإنسان وفعل الله. نعم، إن تفسيرهم لذلك لا يخلو من تعقيد وإبهام ولا يؤدي لغير الجبر، لكنهم لا يلتزمون بلوازم ما أدى إليه بحثهم في مخلوقية أفعال الإنسان.
ربما حام علماء الأشاعرة عبر القرون حول الأمر بين الأمرين ولكن على غير بصيرة كتلك المستوحاة من أمثال كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. فقد ورد في توحيد الصدوق عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: «إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون. فسئلا (عليهما السلام) هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض». إن هذه المنزلة لها أبحاثها الخاصة لدى العلماء من الخاصة. ربما يقال: إن الأشاعرة يدورون حول هذه المنزلة ولكن بسبب المقدمات الباطلة وفهمهم الخاطئ لآيات القرآن الكريم ضلوا عن الطريق وصاروا إلى الجبر من حيث لا يشعرون. ولعل من أكثر من اقترب من نظرية الإمامية في هذا المجال هو صاحب فواتح الرحموت حيث أشار إلى قول الصادق (عليه السلام) وقوى مفهوم الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين، وإن لم يستوف الكلام في ذلك ولم يتعد مرحلة المفهوم إلى مرحلة التفسير. ولكنه خالف في هذا صاحب مسلم الثبوت الذي أنكر هذه المنزلة بين الجبر والتفويض من غير أن ينسبها إلى الصادق صلوات الله وسلامه عليه(21).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
* الهوامش:
(1) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع صفحة 72.
(2) الصافات: 96.
(3) نفس المصدر صفحة 74.
(4) نفس المصدر صفحة 76.
(5) ممـا يقـال ولا حقيقـة عنده معقـولـة تـدنو إلى الأفهـام
الكسب عند الأشعري والحال عنـد البهشمي وطفرة النظام
عن القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب نقلا عن بحوث في الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني 1139.
(6) الصافات: 96.
(7) فاطر: 3.
(8) النحل: 20.
(9) النحل: 17
(10) الطور: 35.
(11) الإبانة عن أصول الديانة صفحة 15-16.
(12) لاحظ منهاج السنة الجزء الأول صفحة 382 وما بعدها.
(13) لاحظ زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الثالث صفحة 228.
(14) القصص: 88.
(15) الأعراف:179.
(16) التفسير الكبير 1563-64.
(17) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الجزء الأول صفحة 41 نقلاً عن استخراج المرام من استقصاء الإفحام للعلم الحجة آية الله السيد حامد حسين اللكهنوي تأليف السيد علي الحسيني الميلاني.
(18) تم الاعتماد في هذا القسم على كتابي بحوث في الملل والنحل والإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل للعلامة المحقق الشيخ جعفر السبحاني.
(19) شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني صفحة 115 نقلا عن كتاب الإلهيات الجزء الثاني صفحة 277.
(20) الإلهيات الجزء الثاني صفحة 279.
(21) فواتح الرحموت الجزء الأول صفحة 36.



















0 التعليق
ارسال التعليق