
الملخّص:
وردت طائفة من الرّوايات في كتاب كامل الزيارات تتحدّث عن تفاعل خاصٍّ لطائر البوم مع مقتل الإمام الحسينg، وحاول المقال بحثها ونقدها منطلقاً من مبرّرات عدّة، وقد عُرِض لهذه الروايات بالتّوصيف السّنديِّ والدلاليِّ أولاً، وفي المرحلة التّالية، تمّ تقديم نقدٍ سنديٍّ وتوثيقيٍّ لهذه الروايات. وأمّا المرحلة الأخيرة، والتّي تمثّل الغرض المحوريّ للمقال، فهو نقدها دلاليّاً وعرضها على المعطيات العقليّة والقرآنيّة والروائيّة والتاريخيّة والعلميّة.
المقدّمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على سيدنا محمد، وآله الطيبين الطاهرين..
يقدّم الدين -بمعناه الواسع- عادّة قراءة للواقع تجتاز ما يمكن كشفه بالحسّ، فهو إذ يفتحُ الإدراكَ على عالمٍ لا تناله الحواسّ، أو عالم غيبٍ في مقابل عالم الشهادة، هو في الوقت نفسه يربط العالَمين ببعضهما البعض، ويُخضع العالمين لقوانين تكوينية مشتركة، تحوي عناصر غيب وشهادة تؤثّر وتتأثّر ببعضها البعض.
وصحيح أنَّ البحث الفلسفي يتكفَّل بكثير من قضايا تتجاوز العالم المحسوس وتشمَلُه، إلا أنّ الدّين عادة يقدّم عرضاً أكثر تفصيلاً وحيويَّة واختزالاً للمعنى. ففي حين قد يثبت الفيلسوف وجود موجودات مجرّدة، يأتي النَّص الدّيني ويعبّر عنها بالملائكة ويشخّصها، ويبرز أدوارها، ويسبغ عليها أوصاف تفصيليّة عديدة.
والدّينُ الحقُّ هومن يملك السرديَّة الواقعيَّة عن ذلك العالم، ويكشف عن حقيقة ارتباط المحسوس بغير المحسوس وتفاصيله. كما أنَّه يُظهر هذه القضايا ويكشفها بنحو متوازن، يحقّق أغراضه التربويَّة لكمال الفرد والمجتمع، فهولا يفرّط في إلغاء الشهادة، فجعل الشهادة غيباً في أذهان الناس، مغرقاً الإنسان في رهبانيّة في الذهن والسّلوك، كما أنّه لا يحبس الإنسان في عالم المادة والكون الميكانيكي فاقداً لمعنى الروح وتحرّرها من سطوة العلل الفيزيائيَّة.
وكثيراً ما نجد في النّص الدّيني إسلاميّاً، قرآناً وسنَّة، تعاصراً وتفاعلاً بين الغيب والشهادة. فمن الموارد التي يربط فيها النَّص القرآني، المحسوس باللامحسوس، الآيات التي تسند الظواهر الطبيعية إلى الله تعالى مباشرةً، أو تكشف عن دَوْر الملائكة فيها. ومن الموارد أيضاً ما يربط فيها بين ظواهر ماديّة وبعض الأحداث والمواقف، كهلاك الأقوام وكفرهم، وصلاح الطبيعة واستقامة الناس.
غير أنَّه ليس من الواضح أنّ هذه الآثار والعلاقات بين الماديّ والغيبيّ هو تجاوز للعلاقات الخاصة داخل المادة دائماً. وبعبارة أخرى، بعض هذه الظواهر قابلة للتفسير ماديّاً، لكنَّها لا تنفي دخالة عنصر غيبيٍّ([1]) كما في قوله تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} (السجدة : 11). وبعض هذه الظواهر قد لا تكون قابلة للتفسير الماديّ، بمعنى أنها ليست خاضعة للقانون الماديّ المعتاد، أي لا يمكن إسناد الظاهرة المادية الملحوظة إلى ظاهرة مادية أخرى، كما في الحوادث الإعجازيَّة([2])، وهذه الحالات أندر من النادر بلحاظ ما يجري وفق العادة. وعلى أي حال، لا ينبغي التسرّع في حمل هذه النصوص على ما يتجاوز القانون الطبيعيّ المعهود إلا أنْ يكون النَّص غير قابل للتأويل والحمل المقبول على ما ينسجم معه، وهذا أمرٌ طبيعيّ بالنّظر إلى الدليل الاستقرائيّ والاحتماليّ.
ومن القضايا التي أبرزها النّص الدينيّ -وهنا السنة تحديداً- من أثر غير المحسوس في ظواهر محسوسة، ما نُقل من الآثار التكوينيّة الماديَّة غير الاعتياديّة لمقتل سيّد الشهداء الإمام الحسينg. فقد نُقل إمطار السماء دماً، وكسف الشمس، ووجدان الدم العبيط في مواطن مختلفة، وغيرها. ولا يوجد إشكالٌ في أصل مثل هذه الظواهر لا فلسفيّاً ولا قرآنيّاً، لما قلناه من وجود علاقة بين الغيب والشهادة، ثابتة بالعقل والنقل. ولا محذور في أنّ الله a خلق هذه الظواهر إشعاراً بعظمة الحدث، أو أوجد سنّة وقوانين تتعدّى المحسوس تقتضي شيئاً من ذلك. غير أنَّ هذه الكبرى لا تعفي من البحث عن سلامة هذه الصغريات؛ لعدم لزوم الإمكانِ للوقوعِ.
وهناك عدّة أمور ترسّخ قيمة البحث في الأخبار من هذا النوع، منها:
الأمر الأول: البحث عن الواقع والحقيقة، وهو مطلب فطريّ إنسانيّ، وتكليف دينيّ.
الأمر الثاني: إنَّ الموقف الذي يتّخذ إزاء أيّ حدَثٍ لا بدَّ أنْ يُبنى على الواقع أو أقصى ما يصلُ إليه جهد الإنسان منه، لا على حدسيّات أو ميول عاطفية، أو نقول غير ثابتة، أوثبت بطلانها.
الأمر الثالث: -وهو امتداد للسابق- إنَّ الحدث الذي يراد له أنْ يبقى في وجدان الأمّة وأبنائها مؤثّراً، ليس غنيّاً عن المبرّرات الموضوعيّة والتاريخيّة، وغير مكتفيّاً بالحيويّة العاطفيّة. وبعبارة أخرى، كلُّ قضية تنسب إلى الحدث العاشورائي العظيم، وتفتقد الموثوقية التاريخيَّة وتمتلئ بالشكوك الموضوعيَّة، تكون موهنة في حقّ الحدث وصاحب الحدثg.
الأمر الرابع: إنَّ وجود بعض القراءات الغيبيَّة للدّين والنَّص الدّيني، قد يؤدّي إلى تغييب دور الشهادة، وأثَر العناصر الماديَّة، وإلى تهميش السننِ الطبيعية في ثقافة الإنسان المؤمن، ما أسهم في ضعف العقليَّة العلميَّة والتجريبيَّة لديه. لذلك تجد كثيراً من النّاس سريعي التّصديق لأيّ قضية تتجاوز القانون الطبيعيّ ولو لم تكن بنقول موثوقة مقبولة، بل ولو ثبت بطلانها بالأدلة العقليّة والعقلائيّة. وكمثال، إنَّ اعتبار آية {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} جواباً تامّاً عن سؤال "لماذا يموت الإنسان؟" يعدُّ تعطيلاً ذهنيّاً لضرورة البحث والتقصّي في العلل القريبة، والتي رسّخها نفس القرآن الكريم من خلال التأكيد على السنن والقوانين وبناء كلّ شيء وتقديره. فلا بدَّ من فهم الآية في سياق التعبير عن دور غيبيٍّ في المعادلة، يفعل من خلال المحسوس، أو يكون متمِّماً وعنصراً أخيراً.
ومن الموارد التي تستدعي البحث والتأمّل الرواياتُ الواردة في تفاعل طائر البوم ومقتل الإمام الحسينg، وهي وإنْ كانت غير حاضرة في الخطاب العاشورائي بوضوح، مكتوباً أو مسموعاً، إلا أنّ المهمّ عندنا هو إعمال التأمّل فيها بما يسري في جميع نظائرها من الروايات، وإعمالاً لنقد المتن وغربلته.
ونريد هنا، أولاً، أن نعرض هذه الروايات، ونسجلّ دلالتها، ونوصّف أسانيدها. وثانيّاً نتوقّف عند نقدها في الجهة السنديّة. وقبل الخاتمة ثالثاً، نتحوّل إلى المحطّة الأهمّ وهو النقد المضموني والمتني لهذه الروايات.
ولا نريد أن نخرج بخلاصة في تقييم الرواية، وحسم أمر صدورها، وإنّما نثير مناقشة مبتنية على دلالتها الظاهرة. ولا يُعدَمُ إمكانُ حملها على وجوه خفيت عنّا، ويمكن قبولها بلحاظ أوجه النقد التي ذُكرت.
أسأل الله تعالى أن يتقبّل هذه السطور، ويحسبها خدمة لدينه، إنَّه سميع مجيب.
النقطة الأولى: عَرْضُ الرّواياتِ وَتَوْصيفُها سَنَداً ودَلالَةً
أورد ابن قولويه القميS في كامل الزيارات([3]) باباً بعنوان نوح البوم ومصيبتها على الحسينg، وذكر فيه أربع روايات، ولا يوجد مصدر أصليٌّ آخر ذكر هذه الروايات، ومن جاء بعده لم يرو إلا عنه. ونعرض هذه الروايات بالترتيب في الباب المشار إليه، مع توصيف السند قبل تقييمه، وتدوين أهم ما يظهر منها من دلالات يراد تقييمها.
الرّواية الأولى:
قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ وَجَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ g قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْبُومَةِ، قَالَ: >هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَآهَا بِالنَّهَارِ؟<. قِيلَ لَهُ: لاَ تَكَادُ تَظْهَرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَظْهَرُ إِلاَّ لَيْلاً. قَالَ: >أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَأْوِي الْعُمْرَانَ أَبَداً فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ اَلْحُسَيْنُg آلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ لاَ تَأْوِيَ الْعُمْرَانَ أَبَداً وَلاَ تَأْوِيَ إِلاَّ الْخَرَابَ فَلاَ تَزَالُ نَهَارَهَا صَائِمَةً حَزِينَةً حَتَّى يَجُنَّهَا اللَّيْلُ فَإِذَا جَنَّهَا اللَّيْلُ فَلاَ تَزَالُ تَرِنُّ [تَرِثُ] عَلَى اَلْحُسَيْنِg حَتَّى تُصْبِحَ<.
لا يوجد إشكالٌ في الاتصال السنديّ كما يبدو، إلا أنَّ هناك مورداً محتملاً للتأمّل في رواية الحسين بن أبي غُندر عن الصادقg مباشرة. وذلك أنّه لم يرو مباشرة عنه أبداً إلا في هذا المورد ومورد آخر، ويروي عادة عن الباقرg بواسطتين، وعن الصادقg بواسطة، وعن الكاظمg مباشرة.
وألفاظ الرواية واضحة، والاختلاف في لفظ ترن وترث قد يكون ناشئاً من تصحيف في نسخ الكامل، وما أثبته البحار هو الأوّل، وهو أرجح لأنَّ مضارع رثى ترثي وليس ترث، وإنما هو مضارع ورث وهو غير مقصود البتة. نعم، ذكر السيد هاشم في مدينة المعاجز ترثي([4]).
محور الحديث في الرواية عن نوع طائر البوم لا بومة بعينها كما هو واضح، فاللام في "البومة" لام الجنس، بخلاف ما قد يظهر من روايات أخرى. وقد ذكرت الرواية في جواب الإمامg أنَّ طائر البوم كان يعيش في العمران، أي كان طائراً أهليّاً ربما. ثمَّ إنّ سلوكه تغيّر بعد مقتل الإمام الحسينg فأصبح يعيش في غير العمران من الأبنية الخربة. وسبب هذا التحوّل هو قرار وعزم من هذا الطائر باعثه إدراكه لهول المصيبة، وهي لا تطعم شيئاً في النهار، فهي تصوم بمعنى أنها تمتنع عن الأكل حتى مع توافره، وتمضيه حزينة. ثم إنّها تبدأ في الليل بإصدار الأصوات التي تكشف عن تحزّنها على الحسينg.
الرواية الثانية:
قال: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَاعِدٍ الْبَرْبَرِيِّ قَيِّماً لِقَبْرِ اَلرِّضَاg قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اَلرِّضَاg فَقَالَ لِي: >تَرَى هَذِهِ الْبُومَ مَا يَقُولُ النَّاسُ<، قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ جِئْنَا نَسْأَلُكَ. فَقَالَ: >هَذِهِ الْبُومَةُ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِe تَأْوِي الْمَنَازِلَ وَالْقُصُورَ وَالدُّورَ وَكَانَتْ إِذَا أَكَلَ النَّاسُ الطَّعَامَ تَطِيرُ وَتَقَعُ أَمَامَهُمْ فَيُرْمَى إِلَيْهَا بِالطَّعَامِ وَتُسْقَى وَتَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا قُتِلَ اَلْحُسَيْنُg خَرَجَتْ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ وَالْجِبَالِ وَالْبَرَارِي وَقَالَتْ: بِئْسَ الْأُمَّةُ أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ اِبْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَلاَ آمَنُكُمْ عَلَى نَفْسِي<([5]).
وحكيم رُوي عنه كثيراً في كامل الزيارات وجميعها عن سلمة إلا موضعاً واحداً من ثمانية وعشرين موضعاً. وورد في السّند سلمة بن أبي الخطاب، والصحيح كما يذهب إليه السيد الخوئي سلمة بن الخطاب، وما ورد في الكامل ليس إلا سلمة بن الخطاب فيما عدا الرواية المذكورة، كما أنّ في البحار إثبات لنفس الاسم المشهور في هذه الرواية. وأما الحسين بن صاعد فلم يُروعنه ولا عن أبيه إلا هذه الرّواية في جميع مصادرنا الروائيَّة.
سؤال الإمامg في الرواية ظاهره عن جنس البوم؛ فإنّ البوم جمع، وتأنيث الإشارة وإفرادها لجمع الحيوان معهود، فيقال: هذه الإبل. وقد تكون إشارة إلى مجموعة خارجية من البوم كانت معاصرة لذلك الزمان والمكان أيضاً. على أنَّ الجواب ظاهره عن طائر بوم معيّن حيث عبّر بـ "هذه البومة". فهي بومة أدركت عصر النبيe، وكما دلّت الرواية السابقة كانت تسكن العمران، وتأكل من طعام الناس أيضاً، ثمّ بعد مقتل الحسينg سكنت الأبنية الخربة والجبال والأماكن المفتوحة، وكان ذلك بسبب خوفها على نفسها، فإنّ من يبطش بالأشرف أهون عليه أن يبطش بالأدون. ولكنْ بذلك لا يكون الجواب متناسباً مع السؤال الافتتاحي للإمامg، إذ سأل عن نوع البوم. ولذلك فالراجح أن يكون الجواب هوعن نوع البوم إمّا بالمطابقة، أو بالالتزام بكون البومة المشار إليها مثالاً.
الرواية الثالثة:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِg قَالَ: >إِنَّ الْبُومَ لَتَصُومُ النَّهَارَ فَإِذَا أَفْطَرَتْ أَنْدَبَتْ عَلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّg حَتَّى تُصْبِحَ<([6]).
وقد روي في الكامل كثيراً عن محمّد بن جعفر الرزّاز، وكثير من رواياته عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (ما ينيف على السبعين مورداً). ومحمد بن الحسين روى في موردين عن الحسن بن فضال.
ذكر صاحب البحار([7]) الرواية بلفظ آخر، حيث نقل "وتدلّهت" بدل "أندبت". قال صاحب العين: "الدَّلَهُ: ذَهابُ الفُؤاد من هَمٍّ، كما تُدَلَّهُ المرأةُ على وَلَدها إذا فَقَدَتْه"([8]). ولعلّ السياق يتقاضى الندبة دون الدّلَه، فإنّ حالة الحزن تلازم الفقد ولا معنى لتقييدها بالليل أو النهار عادةً، وإنما يستجد ويشتد وتظهر مظاهره من قبيل الندبة وغيرها.
وتتضمّن هذه الرواية مفاداً ذكرته الرواية الأولى وهو وصوم البوم النهاريّ وإصداره الأصوات الدالّة على الحزن في الليل. وموضوعها ظاهراً نوع البوم وليس بومة مشخّصة، ولا مجموعة مشخّصة، ولا سلالة معيّنة.
الرواية الرابعة:
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِيثَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِg: >يَا يَعْقُوبُ رَأَيْتَ بُومَةً بِالنَّهَارِ تَنَفَّسُ قَطُّ< فَقَالَ: لاَ، قَالَ: >وَتَدْرِي لِمَ ذَلِكَ؟< قَالَ: لاَ، قَالَ: >لِأَنَّهَا تَظَلُّ يَوْمَهَا صَائِمَةً عَلَى مَا رَزَقَهَا اللَّهُ فَإِذَا جَنَّهَا اللَّيْلُ أَفْطَرَتْ عَلَى مَا رُزِقَتْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تَرَنَّمُ عَلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّg حَتَّى تُصْبِحَ<([9]).
ويوجد في هذه الرواية غرابةٌ من جهة رواية سعد عن الإمام الصادقg بواسطتين؛ فغالباً يروي عنه× بأربع وسائط، بل أحياناً خمس، وأحياناً ثلاث، ولم يتكرّر في الكتاب المذكور رواية بواسطتين إلا اثنتان. كما أنّ موسى بن عمر لم يرو إلا بواسطتين، ولعلّ هذا باعث للشكّ الموضوعيّ في اتصال السّند.
هذا، إضافة إلى ملاحظة التغاير بين المخاطب والراوي عن الإمامg؛ فإنَّ الإمامg قال: يا يعقوب، بينما الراوي هو الحسن. وفي توجيه ذلك، ذُكر أنَّ الراوي هو يعقوب بن شعيب الميثمي، أو أنَّ المروي عنه من قبل الحسن اسمه يعقوب، أو أنَّ الإمامg قال: يا أبا يعقوب -كما نقل صاحب البحار "يا أبا يعقوب"-، وهي كنية الحسن الميثمي.
وعلى أيّ حال، فإنّ رواية سعد عن موسى بن عمر متكرّرة، وأما رواية موسى عن الحسن بن علي الميثمي فلم توجد إلا في هذه الرواية، نعم روى عن الميثمي لكنّه مشترك.
وهناك أمر آخر وهو تعبير "صائمة على ما رزقها الله"، فإمّا أنْ يكون المقصود أنّها صائمة عن ما رزقها الله، فيكون تصحيف أو تضمين على معنى عن، أو أنْ يكون متعلّقاً بحال و "ما" مصدرية، أي على رزق الله لها، أي برغم رزق الله لها، كما تقول: "هو صائم على أنّه جائع".
والرواية تتحدّث عن عموم جنس البوم، للعموم المذكور في جواب السائل حيث قال: "لا"، أي لم يرَ بومة قطّ. وتتضمّن أمراً ذكرته الرواية الأولى أيضاً.
خلاصة:
ويمكن تسجيل خلاصة الدلالات التي تعني هذا البحث من مجموع هذه الروايات:
- نوع طائر البوم كان يسكن العمران قبل مقتل الحسينg.
- بعد مقتل الإمام الحسينg، هجر البوم العمران إلى الأبنية الخربة، أو الجبال، أو البراري.
- سبب هجرانه ناشئ من عزم وقرار، بسبب خوفه على نفسه.
- كان البوم يطعم ممّا يعطونه الناس.
- سلوك البوم تحوّل من الظهور نهاراً -كما هي الطيور عادة- إلى الاختفاء نهاراً والظهور ليلاً.
- تصوم البوم نهاراً حتى مع توافر الطعام، وتبدأ الأكل ليلاً.
- تصدر أصواتاً ليلاً حزناً وندبة على الإمام الحسينg.
وتختصّ الرواية الثانية بإمكان حملها على بومة شخصية، أو سلالة ومجموعة خاصّة وخارجية آنذاك. كما تقبل الروايات الأخرى الحمل على مجموعة خاصّة أيضاً، لكنّه خلاف الظاهر.
النقطة الثانية: النَّقْدُ السَّنَديُّ والتَوْثيقِيُّ
فيما عدا الرّواية الأولى، تعاني الروايات من خلل سنديّ واحد في الحدّ الأدنى، ولا يمكن اعتبارها بناءً على مبنى الوثاقة على الأقلّ. وأما الأولى فيمكن القول باعتبارها بناءً على بعض المباني. ونعرض لذلك بالترتيب:
الرواية الأولى:
الرواية الأولى مسندة وبعض رجالها ثقات اتفاقاً. وما يمكن التوقّف فيه هما رجلان:
الأول: هو محمد بن عيسى بن عبيد، وقد وقع فيه بحث معروف؛ حيث تعارض فيه توثيق الشيخ النجاشي مع تضعيف الشيخ الطوسي.
قال الشيخ الطوسي: "(محمد) بن عيسى بن عبيد اليقطيني بن يونس ضعيف"([10]). وذكر الشيخ في الفهرست استثناء أبي جعفر إيّاه في نوادر الحكمة. وقد قدح فيه ابن طاووس والشهيد الثاني من جهة وقوعه في كثير من أسانيد روايات ذمّ زرارة.
وأمّا النجاشي فقد قال عنه: "جليل في (من) أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف"([11])، وعرض لرأي محمد بن الوليد في تضعيفه بخصوص ما تفرّد به عن يونس، ونقل إنكار الأصحاب إليه، وكما ذكر مدح ثناء ابن شاذان عليه.
وقد خلص السيد الخوئي إلى توثيقه حيث قال: "ولكن الصحيح أنّ الرّجل لا إشكال في وثاقته وصحّة رواياته"([12]). وذكر جملة من معالجة موجبات الشك في وثاقته([13]).
والثاني: هو الحسين بن أبي غندر، فإنّه لم يرد فيه توثيق أو تضعيف([14]). لكنْ ذهب البعض إلى وثاقته بناءً على كبرى رواية المشايخ الثلاثة؛ حيث روى عنه صفوان بن يحيى، بل لم يروعنه غيره([15]).
والخلاصة: أنّ الرواية معتبرة لو عالجنا ورجحنا وجه التوثيق في التعارض في شأن محمد بن عيسى، وقبلنا كبرى رواية المشايخ الثلاثة.
الرواية الثانية:
أمّا حكيم بن داود فلم يرد فيه توثيق، إلا أنَّه من رجال كامل الزيارات الذين روى عنهم بالمباشرة، فبناءً على قبول هذه الكبرى يمكن توثيقه.
وأمّا سلمة بن الخطاب فقد ضعّفه النّجاشي بقوله: "سلمة بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني الأزدورقاني، قرية من سواد الري كان ضعيفاً في حديثه له عدة كتب"([16]). وورد في كتاب ابن الغضائريّ: "سَلَمَةُ بنُ الخَطّاب، البَراوَسْتائيُّ، أبُو مُحمّد، من سَواد الرَيّ. ضَعِيْفٌ"([17]).
وذيّل السيد الخوئي في المعجم حديثه في وثاقته بقوله: "أقول: يحكم بضعف الرجل لتضعيف النجاشي إياه، وأما رواية الأجلاء عنه ولا سيما محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته فليس فيها دلالة على الوثاقة كما تقدم"([18]).
وأما الحسين بن علي بن صاعد وأبوه فمجهولان، ولم يشَر إليهما في أيٍّ من الكتب الرجالية المتقدّمة. كما لم يُروعنهما إلا هذه الرواية كما سلف.
والخلاصة: أنَّ الرواية لاحتوائها على المجاهيل والضعفاء لا يمكن القول باعتبارها.
الرواية الثالثة:
الرواية مرسلة -كما هو واضح- حيث لم يصرّح باسم الواسطة بين ابن فضال والإمام الصادقg. وأمّا ابن فضال فالخلاف فيه معروف بين من يشترط العدالة في الراوي كالشهيد الثاني وغيره، وبين من يشترط مطلق الوثاقة، والأكثر يبني على وثاقته.
الرواية الرابعة:
وأمّا الرواية الرابعة، فبعيداً عن شبهة الإرسال التي أثيرت سابقاً، يوجد ما يسقطها عن الاعتبار، لرجلين:
الأول: هو موسى بن عمر، وهو مشترك بين عدّة أسماء، قال السيد الخوئي: "أقول: موسى بن عمر هذا، مشترك بين جماعة، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه"([19]). والموثّق بينهم وحيداً هو موسى بن عمر بن بزيع، قال النجاشي: "ثقة، كوفي، له كتاب". وقال الطوسي: "ثقة". والمذكور أيضاً موسى بن عمر بن يزيد، وهو لم يوثّق، قال النجاشي: "موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل مولى بني نهد، أبوعلي، وله ابن اسمه علي، وبه كان يكتنى. له كتاب"([20]).
ولا أقل من الإجمال بعد اشتراك البعض في الطبقة، وإنْ كان الأرجح أن يكون من يروي عنه سعد هو موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، حيث أرود النجاشي " أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدّثنا أحمد بن محمد، عن سعد، عن موسى بكتبه".
الثاني: هو الحسن بن علي الميثمي، وهو مجهول لم يوثّق ولم يذكر.
والخلاصة أنّ الرواية غير معتبرة.
خلاصة التقييم السندي:
والروايات إذن غير معتبرة فيما عدا الأولى على بعض المباني. هذا، إن بنينا على الوثاقة. وأمّا إن كان للوثوق مدخليّة في التقييم، فإنّ النّقد المضموني الآتي من أهم ما يخلّ بالوثوق، على أنَّ كون الرواة بين المجاهيل والضعاف، وممّا انفردوا بهذا المضمون وعدم ورود المضمون في أيّ كتاب آخر، كلّ ذلك ممّا قد لا يشفع للمضمون تعدّده.
النقطة الثالثة: النَّقْدُ الْمَضْمونِيُّ
بصرف النظر عن موثوقيّة صدور الرواية، يبقى تحليل المتن ونقده لازماً من أجل الاعتبار النّهائي للرواية؛ وذلك لأنَّ أقصى ما تثبته الصحة السنديّة تحقيق موضوع صالح لأدلة حجية أخبار الثقة، غير أنَّ الموانع قد تعترض ذلك وتمنع الحجيَّة، كما لو اطمأننّا لقرائن داخلية لغوية معيّنة بعدم الصدور، أو معارضتها للمعلوم من الكتاب أو السنّة القطعيّة، أو أيّ طريق معرفيٍّ عقليٍّ أو عقلائيٍّ.
سنحاول أن نستقصي ما يمكن أن يكون مانعاً من قبول الرواية، من معطى قرآنيّ، أو روائيّ، أو تاريخيّ، أو علميّ طبيعيّ.
أولاً: المعطى الفلسفيّ والقرآنيّ
أمّا فلسفيّاً فلا دليل عقليّاً واضحاً يحيلُ حصول شيء من هذا القبيل. وقرآنيّاً لا يوجد أيضاً ما يتضادّ بنحو بيّن مع مفاد هذه الروايات.
ثانياً: المعطى الروائيّ
وأما المعطى الروائي فتطالعنا فيه نصوص قد يقال بتعارضها مع الروايات محلّ البحث، نذكر منها ما يلي:
موت إبراهيم بن رسول اللهe وكسوف الشمس
روى الكليني عن عَلِيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَىg يَقُولُ: >إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِe جَرَتْ فِيهِ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِفَقْدِ اِبْنِ رَسُولِ اَللَّهِe فَصَعِدَ رَسُولُ اَللَّهِe اَلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ واَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ تَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اِنْكَسَفَتَا أَو وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ<([21]).
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني، وكذا البرقي في المحاسن عن أَبُي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ([22]).
وقد ورد بطرق أهل السنّة كما في صحيح البخاري([23])، وسنن النسائي([24])، ومسند أحمد([25])، وصحيح ابن حبان([26])، وغيرهم.
يدلُّ الحديث على أنَّ جريان الشمس والقمر يمضي وفق سنَّة إلهيَّة، ولا شكَّ أنَّ الأسباب القريبة الطبيعيَّة جزء من هذه السنَّة. كما يدلّ على نفي أنْ يكون موت أحدٍ ما، مهما كان مقامُه، جزءاً من هذه السنَّة وجزءاً من أسباب تحقّق الكسوف والخسوف. ولا خصوصيَّة للشمس والقمر، فليس هما فقط مصداق للآية الإلهيَّة، بل هما مثال للآيات والظواهر الطبيعيَّة عموماً. وأيضاً لا خصوصيَّة لحدث الموت في النَّفي، بل كلُّ حدث بشريٍّ واجتماعيٍّ ليس له أثرٌ في عرض السنن الطبيعيَّة إلا بما تكون هي في طوله. ومن ضمن الظواهر الطبيعيَّة السلوك العامّ لنوع الحيوان؛ فإنَّه ناتج عن طبيعته وخصائصه.
وبالتالي يمكن أنْ يقال: إنَّ هذه الطائفة من الروايات تعارض روايات البومة؛ وذلك لأنَّها تفترض أنّ ظاهرة طبيعيّة عامَّة ناشئة من حدث مقتل الإمام الحسين×، وليس عن عوامل طبيعيَّة.
وممّا يتصادم بشكل أوضح مع هذه الرواية ما ذكر في كامل الزيارات >يَا زُرَارَةُ إِنَّ اَلسَّمَاءَ بَكَتْ عَلَى اَلْحُسَيْنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالدَّمِ، وإِنَّ اَلْأَرْضَ بَكَتْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالسَّوَادِ، وَإِنَّ اَلشَّمْسَ بَكَتْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْكُسُوفِ واَلْحُمْرَةِ<([27]). فهي على ما فيها من ضعف سنديّ، وبواعث واضحة للتأمّل التاريخيّ، تتصادم مع الرواية المذكورة.
ولكنَّ المناقشة قابلة للتأمّل لعدَّة أمور:
1- ضعف أسانيد الروايات المذكورة، فإنَّ رواية الكليني فيها المجهول، ورواية المحاسن -لو تجاوزنا البحث في نسبته- فيها الضعيف كما يظهر.
لكنّ هذه المناقشة قابلة للتأمّل؛ لتعدّد طرق الرواية لو بنينا على الوثاقة.
2- إنَّها ليست آبية عن تخصيصها بالروايات المذكورة، خصوصاً مع ملاحظة امتياز فاجعة الطفِّ.
3- إنّ كثيراً من النّصوص تدلّ على وقوع آثار كونيّة من هذا القبيل، خصوصاً ما يتعلق بمقتل الإمام الحسينg. ولئن ابتُلي بعضها بالضّعف، فإنّ منها الصحيح وما ادّعي فيه التواتر أيضاً.
ب) حديث البومة في توحيد المفضّل
ورد عن الصادقg في توحيد المفضّل أو كتاب فكّر: >أَعَلِمْتَ مَا طُعْمُ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنَ اَلطَّيْرِ اَلَّتِي لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ كَمِثْلِ اَلْبُومِ واَلْهَامِ واَلْخُفَّاشِ؟ قُلْتُ: لاَ يَا مَوْلاَيَ. قَالَ: إِنَّ مَعَاشَهَا مِنْ ضُرُوبٍ تَنْتَشِرُ فِي اَلْجَو مِنَ اَلْبَعُوضِ واَلْفَرَاشِ وأَشْبَاهِ اَلْجَرَادِ واَلْيَعَاسِيبِ، وذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ اَلضُّرُوبَ مَبْثُوثَةٌ فِي اَلْجَو لاَ يَخْلُو مِنْهَا مَوْضِعٌ، واِعْتَبِرْ ذَلِكَ بِأَنَّكَ إِذَا وَضَعْتَ سِرَاجاً بِاللَّيْلِ فِي سَطْحٍ أَو عَرْصَةِ دَارٍ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ اَلضُّرُوبِ شَيْءٌ كَثِيرٌ<([28]).
وظاهر الرواية أنَّ البوم كائن ليليّ باقتضاء طبيعيّ وذلك لأنَّ غذاءه يتوافر ليلاً، وهو خلاف ظاهر الروايات محلّ البحث. صحيحٌ أنّه يمكن افتراض عروض هذا اللون من السلوك الغذائيّ على البوم والرواية تتحدّث عنه بعد التغيّر لا قبله، لكنّه بعيد بحسب ظاهر الرواية.
ولكن يبقى الإشكال في المناقشة من قِبل اعتبار كتاب توحيد المفضّل نفسه، بلحاظ جهات سنديّة ومتنيّة([29]).
ج) رواية المناقب
ورد في المناقب لابن شهر آشوب: أَبُوبَكْرٍ اَلشِّيرَازِيُّ فِي نُزُولِ اَلْقُرْآنِ فِي شَأْنِ عَلِيٍّg بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَg: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَةَ}: >عَرَضَ اَللَّهُ أَمَانَتِي عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ بِالثَّوَابِ واَلْعِقَابِ فَقُلْنَ رَبَّنَا لاَ تُحَمِّلْنَا بِالثَّوَابِ واَلْعِقَابِ لَكِنَّا نَحْمِلُهَا بِلاَ ثَوَابٍ ولاَ عِقَابٍ، وإِنَّ اَللَّهَ عَرَضَ أَمَانَتِي ووَلاَيَتِي عَلَى اَلطُّيُورِ فَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهَا اَلْبُزَاةُ اَلْبِيضُ واَلْقَنَابِرُ، وأَوَّلُ مَنْ جَحَدَهَا اَلْبُومُ واَلْعَنْقَاءُ، فَلَعَنَهُمَا اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِ اَلطُّيُورِ، فَأَمَّا اَلْبُومُ فَلاَ تَقْدِرُ أَنْ تَظْهَرَ بِالنَّهَارِ لِبُغْضِ اَلطَّيْرِ لَهَا، وأَمَّا اَلْعَنْقَاءُ فَغَابَتْ فِي اَلْبِحَارِ لاَ تُرَى، وإِنَّ اَللَّهَ عَرَضَ أَمَانَتِي عَلَى اَلْأَرَضِينَ فَكُلُّ بُقْعَةٍ آمَنَتْ بِوَلاَيَتِي جَعَلَهَا طَيِّبَةً زَكِيَّةً، وجَعَلَ نَبَاتَهَا وثَمَرَهَا حُلْواً عَذْباً، وجَعَلَ مَاءَهَا زُلاَلاً، وكُلُّ بُقْعَةٍ جَحَدَتْ إِمَامَتِي وأَنْكَرَتْ وَلاَيَتِي جَعَلَهَا سَبِخاً، وجَعَلَ نَبَاتَهَا مُرّاً عَلْقَماً، وجَعَلَ ثَمَرَهَا اَلْعَوْسَجَ واَلْحَنْظَلَ، وجَعَلَ مَاءَهَا مِلْحاً أُجَاجاً. ثُمَّ قَالَ: وحَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ، يَعْنِي أُمَّتَكَ يَا مُحَمَّدُ وَلاَيَةَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وإِمَامَتَهُ بِمَا فِيهَا مِنَ اَلثَّوَابِ واَلْعِقَابِ، إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً لِنَفْسِهِ جَهُولاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا بِحَقِّهَا فَهُو ظَلُومٌ غَشُومٌ<.
وتدلّ الرواية على أنّ سبب كون البوم كائناً ليليّاً جحدها لولاية أمير المؤمنين× التي عرضت عليها. وهذا العرض يبدو أنَّه في نشأة سابقة. وعلى أيّ حال فهي تتنافى مع روايات البومة محلّ البحث.
ولكنّ الرواية لا يمكن قبولها. أما أولاً فمن جهة اعتبارها السنديّ وضعفها بالإرسال، وثانياً -وليكن ذلك مؤيّداً في التوقّف عن القبول- وجود العنقاء في النّص الذي يُتَّفق على أنّه كائن خرافيٌّ، ويشهد لذلك الأوصاف التي تسند إليه في أذهان العرب آنذاك، بل غيرهم، بعد عدم وجود قرينة على إرادة غير المعنى العرفي. أضف إلى أنّ التنوّع الحيويّ والجغرافيّ كلّه من لوازم نظم الأرض؛ فإنّ الأراضي القاحلة والسبخة لها دورها في ضمان بيئة حيويّة معيّنة، كما أنّ البيئات المثمرة الأخرى، والنبات الذي ينمو في الأولى ملائم لبيئته وللكائنات الحيّة فيه، كما هو الحال ما في الثانية. وبعبارة أخرى: يُتأمَّل في تفاضل شيء على شيء إلا بلحاظ ما يحقّقه من أغراض حيويّة، هي موجودة في الأمرين.
وهناك روايات أخرى أيضاً لكنّها ضعيفة. وبذلك يتبيّن أنْ لا وجود لمدلول روائيّ مقطوع يتضادّ والروايات مظنّ البحث، إلّا أنْ يقال: إنّ اجتماع هذه الروايات المعارِضة في مدلول التزامي وإنْ لم يوجد القطع غير أنّه قد يخلّ بتحصيل الوثوق.
ثالثاً: المعطى التاريخيّ
وأمّا المعطى التاريخي فيوجد شواهد ُعديدةٌ على أنّ طائر البوم منذ أنْ عرفه الإنسان طائرٌ جارحٌ ليليٌّ لم يتغيّر سلوكه كما تذكر الروايات مورد النّظر.
ويرجع أقدم وجود للبوم في ذهن الإنسان وثقافته إلى قرابة ثلاثين ألف عام([30])، حيث اكتشف علماء رسوماً في كهوف فرنسية عام 1994م. وتوجد الشواهد الأثريّة على وجوده في الحضارة البابلية، في بعض ما وجد من الفخار. وكذلك المصرية، في رسومات على جدران أبنية الفراعنة. وكذلك الإغريقية، حيث يوجد في العملات المسكوكة الفضية المشهورة. وكذا عند الرومان والصينين وغيرهم([31]).
وكثيراً ما شكّل البوم حضوراً رمزياً في الحضارات البشريَّة المختلفة، بين الحكمة، والعناد، وأداة للآلهة. غير أنّ الرمزيّة التي تكاد لا تخلو منها ثقافة هي ارتباطه بالشرّ والشؤم. ولا يوجد مبررٌّ واضح لهذه الرمزيّة إلا ارتباطه بالظلمة والليل، والبقاء في الأماكن غير المأهولة، والمقابر، وما أشبه. ويسمّي الفراعنة البومة باسمٍ جزؤه يدلّ على مصاحب الروح، في إشارة إلى الخرافة المنتشرة حتى عند العرب من ارتباط البومة بروح الميت بنحو ما. وهذا يناسب سلوك البومة كطائر ليليّ. وينسب إلى الشاعر الرومانيّ (43 ق.م) قوله عن البوم إنه: "نذير شؤم للإنسان، طائر بوم صيّاح نذير للبلاء"([32]).
ويعتقد الصينيّون القدماء أنَّ البومة تستيقظ في حلكة الليل من أجل حماية قبور الموتى. كما أنّه مرتبط عندهم بمفهوم البرق لأنه يضيء في الليل. وفي بعض ثقافات الأمريكيّتين ينظر إلى البوم أنّه إنسان حكيم تحوّل إلى بوم في طقوس ليليّة([33]).
وذكر في كليلة ودمنة البوم بقصة لا تخلو من اختزال الرمزية الأوصاف المعروفة([34]).
وقد ورد في الكتاب المقدّس في سفر المزامير: "أَشْبَهْتُ قُوقَ الْبَرِّيَّةِ صِرْتُ مِثْلَ بُومَةِ الْخِرَبِ"([35]).
وحين نجول في التاريخ والأدب العربيّ الجاهليّ وبُعيده نجد نفس هذه الرمزيات ومثل هذا التوصيف، ما يشير إلى أنّ شيئاً لم يتغيّر في سلوك هذا الطائر.
فقد كان العرب يتشاءمون من البوم، ويسمّونها بـ "أمّ الخراب". كما كانوا يعتقدون بأنَّها روح الميت ترفرف على القبر([36]). وكلّ هذه الرمزيّات والمعتقدات تنسجم مع أنّه طائر ليليٌّ.
وينقل عن المرقش الأكبر، الشاعر الجاهليّ قوله:
قَطَعْتُ إلى مَعْرُوفِها مُنْكَراتها ... بعَيْهَمَةٍ تَنْسَلُّ واللَّيْلُ دامِسُ
وتَسْمَعُ تَزْقاءً منَ البُومِ حَوْلَها ... كما ضُرِبَتْ بَعْدَ الهُدُو النِّوَاقِسُ([37])
وقد نقل الشيخ البهائي في كشكوله([38]) عن الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينg قوله:
أيا بومة قد عششت فوق هامتي ... على الرغم مني حين طار غرابها
رأيت خراب العمر مني فزرتني ... ومأواك من كل الديار خرابها
وجاء في أدب الكاتب نقلاً لقول ذي الرمّة:
" قدْ أعسِفُ النازِحَ المجهولَ مُعْسِفُه ... في ظلِّ أخضرَ يدعُو هامَهُ البُومُ
أي: في ستر ليل أسود"([39]).
وذكر صاحب الأغاني([40]) شعراً لعمرو بن برّاق جاء فيه:
"إذا الليل أدجى واكفهرّت نجومه ... وصاح من الإفراط هام جواثم"
والهامّ البوم، وقد أثبت في العين([41]) وجمهرة اللغة([42]) بوم بدل هام.
وجاء في تهذيب اللغة([43]):
"وقال الأعشى يصف فلاة:
لا يسمع المرء فيها ما يؤنّسه ... باليل إلاّ نئيم البوم والضُّوَعا"
ولا شكّ أنّ هذه النقولات لا توجب اطمئناناً وعلماً بمفردها، ولكن اجتماعها على مفاد واحد، مع افتراقها زمناً وثقافةً وحضارةً يوجب الاطمئنان بصدقه. وهذا المفاد هو أنَّ البوم طائر ليليّ يسكن في الأماكن الخربة في الجملة، وسلوكه لم يتغيّر، وكان ذلك مبعثاً لجعله رمزاً للشرّ ومورداً للتشاؤم، سواء كان ذلك في الجزيرة العربية أم خارجها. فيثبت بذلك أنّ دلالات الروايات الظاهرة من أنّ نوع البومة هجر العمران تتعارض مع معطى معلوم تاريخيّاً، ولا أقل من التشكيك في مضمونها.
وهناك أمرٌ آخر، وهو أنّ هذا التحوّل المباشر في السلوك في نوع البوم، وبالنظر إلى اهتمام البشرية به وكونه محطاً للنظر والترميز، لوكان واقعاً لكان من اللازم أنْ يجد صداه بصورة أو بأخرى في مدوّنات البشر التاريخيّة. وهذه الروايات لا تكفي بالطبع، ولا توازي حجم ظاهرة ملحوظة بهذا القدر.
رابعاً: المعطى العلميّ
وأمّا المُعطى العلمي فما يكشفه علم الأحياء والحيوان هو أنَّ هناك تناسباً وانسجاماً بين خصائص الكائن الحيّ الفسيولوجيّة والحيويّة وبين بيئته وسلوكه، وهذا السلوك من مقتضيات ذلك التكوين([44]).
يوجد رتبة من الطيور تسمّى البوميات، وتحتوي قرابة مئتي نوع، عشرة منها رصد في الجزيرة العربيّة، وهي توجد في مختلف البيئات الحيويّة، و5% منها خارج الغابات، ومعظم هذه الأنواع من المفترسات الليليّة، والقليل من هذه الأنواع يتكيّف مع البقاء نهاراً، وهي تملك مخالب حادّة وقبضة قويّة تمكّنها من الصيد.
ومن أهمّ ما يكيّفها في الصيد ليلاً عيونها؛ إذ تفوق قدرتها البصرية الإنسان بخمسة وثلاثين مرّة. ووزنهما الكبير قد يصل لوزن عين الإنسان، ويمكن وجودهما في أمام الرأس (بخلاف الطيور)، والبعد بينهما رؤية مجسمة تمكّنها من تشخيص أبعاد موقع الفريسة وحركتها وما شابه، وهي أفضل الطيور رؤية تجسيميّة. كما أنّها تدير رأسها مئتين وسبعين درجة لوجود فقرات عديدة في رقبتها. وحجم العين يسمح للبؤبؤ بالاتساع ليملأها، فيدخل مقدار أكبر من الضوء، ما يجعلها قادرة على الرؤية بشكل أفضل ليلاً. وتتشابه البومة مع غيرها من بعض الحيوانات الليلة في شكل العين ما يعني وجود رابطاً بين السلوك الليلي وهذه الخصائص البصريّة.
ويملك البوم سمعاً حادّاً يمكّنه من تحسّس حركات فرائسه، حتى في الظلام حين يعجز بصره عن لمحها.
إضافةً لذلك فإنّ ريش البومة يمتلك خواصّ تجعلها تصدر أصل ما يمكن من الأصوات أثناء طيرانها، ما يوفّر لها فرصة أكبر في مباغتة الفرائس ليلاً، حيث الهدوء يلعب دوراً في التنبّه إلى أيّ صوت خفيف.
وتمتلك البومة صوتاً مميّزاً ومتنوّعاً بحيث يعتبر معياراً لتصنيفها. وقد وجد أنّها أصوات ترتبط بأمور تواصليّة، وتزاوجيّة وغيرها من الوظائف والأغراض الحيويّة.
وعوداً على دلالات الروايات المذكورة، لو كانت صائبة لكان معناه أنّ كلّ هذه الأعضاء كانت متناسبة مع الليل دون النّهار، ومع ذلك كانت تعيش البومة نهاراً، وصدفة وافق تحوّلها في السلوك ما ينسجم مع ما أُعدَّتْ بِه وقدر جسدها عليه. وستكون حيواناً على خلاف الحيوانات يعيش شطراً من تاريخه الطبيعيّ بشكل لا يتناسب مع تكوينه، وليس المحدد لسلوكه هو خصائصه الحيويّة.
وصحيح أنّ هذه المعطيات العلميّة ليست جزميّة، لكنّها بتراكمها تشكّل جواباً أرجح معرفيّاً من مدلول أخبار الآحاد الضعيفة. وحين يتضادّ النّص الديني مشكوك الصدور والذي ليس بحجة، مع أمر طبيعيّ عقلائيّ قد يصل إلى الاطمئنان لا محيص عن تقديمه عليها. بل الفقهاء يقدّمون المعطى العلمي حتى على الصحيح من الروايات، فحتى لو صحّت الروايات المذكورة فإنّها لا تزاحم المعطى العلميّ الاطمئناني؛ لأنّها لا توجب علماً بصحتها.
وهناك شيء آخر، وهو أننا لو فرضنا تغيّر سلوك هذه الطيور في لحظة زمنيّة معيّنة، فكيف اطّلع الغائب منها على ما حصل، ولم يتصل بمن كان حاضراً؟! ثمّ كيف انتقل هذا السلوك إلى الأجيال اللاحقة، والحال أنّ السلوكيات من هذا النوع لا تنتقل للأجيال بنحو يزيل كلّ السّمات السابقة على هذا السلوك، فالسلوكيّات المكتسبة لا تورّث، وحتى لو ورّثت فليس توريثاً مطبقاً.
وقد يتمسّك البعض بمدلول الرواية الثانية، وهو أنّ موضوع الخبر ليس نوع البوم، بل بومة خاصة، ولا يعسر أن يخالف الفرد نوعه في بعض الأمور كما هو واضح. فهناك بومةٌ ما ألفت البشر، كما قد يألف المفترس على غير عادته، ثمّ لمّا قتل الحسينg جرت على ما يوافق طبع نوعها.
وهذا الكلام، بعد تجاوز الضعف السنديّ، والاضطراب الدلالي، لو حمل على هذا المعنى، فهو محل غرابة من جهة أخرى، وهو عمر البومة الممتد إلى ما يزيد على مئة وثلاثين سنة، أيّ الفارق ما بين زمن النبيe والإمام الرضاg. والحال أنّ متوسّط أعمار هذه الطيور لا يجتاز خمسة وعشرين سنة على مختلف أنواعها. وأكثر بومة معمّرة مسجّلة تعيش في المحميّات -تطول عمر الطيور في المحميّات عادة- بلغ ستين سنة. وهذا مثل أنْ تجد إنساناً اليوم عمره مئتان وثمانون سنة تقريباً([45]). وليس في ذلك استحالة فلسفيّة، لكنّ وقوعه ضئيل الاحتمال للغاية، إلا أن يكون إعجازٌ في البين، ولا يبدو من النص إعجازيّة تلك البومة.
ويبقى هناك شيء آخر، وهو وجود إدراك وتعقّل لهذه الكائنات فإنّها تدرك المعصومg، وتعرف الناس، وتعرف الحوادث الواقعة، وتفكّر، وتصمّم على القيام بفعل ما. وحين ملاحظة الكائنات الحيّة لا يوجد ما يدلّ على هذه الدرجة المتقدّمة من الوعي والإدراك. وصحيح أنّ القرآن الكريم يوضّح أنّ المخلوقات تقوم بعمل التسبيح، ولكنّ ليس من الواضح أنّ التسبيح هو حقيقيّ أم هو تنزيل الانقياد والسير وفق الإرادة الإلهيّة تسبيحاً، خصوصاً وأنّ التسبيح موصوف به كلّ شيء، وليس الأحياء فقط، ولا شك أنّ الإدراك لا يصدر من الجمادات.
لكنّ هذه المناقشة في الإدراك ليست تامّة، وذلك لأنّ الإدراك ليس ممّا يمكن للتجربة الكشف عنه إذ هو أمر غير محسوس، نعم خصوص سنخ الإدراك الذي يتصل بالفعل الطبيعيّ. ثمّ إنّ بعض النّصوص تثبت نحواً من الإدراك للحيوان مثل هدهد سليمان، والنمل، فإنّها كانت تتواصل معه وتشخّصه، وليس واضحاً ما إذا كانت هذه الكائنات إعجازيّة أم لا. هذا إضافة إلى دور المعصوم وموقعه الوجوديّ الذي توضّحه كثير من النصوص، الذي يضفي خصوصيّة له وإدراك المخلوقات له.
خامساً: خبر الثقة في الموضوعات
أمّا المناقشة الأخيرة لهذه الروايات فهي أنّ مضمونها خبريٌّ تاريخيٌّ وعلميٌّ، وليس أمراً مرتبطاً بالأحكام الشرعية. وحجية الخبر لا معنى لها على بعض المباني في غير مقام العمل. وعلى أيّ مبنى من المباني، لا يمكن لحجية الخبر أن تقلب عدم العلم إلى علم. هذا إن كان الخبر صحيحاً أو موضوعاً للحجية، وأما إن كان الخبر ضعيفاً فالأمر أوضح.
ملاحظات عامّة:
ونريد قبل الخاتمة أنْ نؤكّد على أمور:
أوّلاً: إنَّ المقال ليس بصدد مناقشة الآثار التكوينيّة لواقعة الطف الأليمة؛ فإنّها ممّا لا يمكن إنكارها بالنظر إلى النصوص المنقولة. ثمّ إنّ الثابت من بكاء النبيe وأحواله مع الحسينg، لا يحتاج إلى ضميمة تبيان مقامه وأليم مصابه. والاقتصار على كثير ما ثبت من الكرامات والفضائل يغني عن التمسّك بما يوجب وهناً في مشهد واقعة الطف من نسبة ما لا يصطدم مع المعطيات المعلومة.
ثانياً: إنَّ المناقشة كانت لخصوص ما تمّ استظهاره من دلالات من هذه الروايات، وبطلان هذه الدلالات لا يلازم بطلان نفس الرواية لو أمكن حملها على معانٍ أخرى. ومع ذلك فإنّ مبرّرات اختلاق أحاديث من هذا القبيل موجودة. فأولاً المخزون العاطفي إزاء الإمام الحسينg وواقعة الطف قد يوجد ثغرة لتسرّب ما يوافقه. ولذلك فمن أبواب الوضع في الروايات الشيعية([46]) ما كان موضوعه فيه غلو أو مبالغة، فقد نقل الكشي عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِg يَقُولُ: >كَانَ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَتَعَمَّدُ اَلْكَذِبَ عَلَى أَبِي، ويَأْخُذُ كُتُبَ أَصْحَابِهِ، وكَانَ أَصْحَابُهُ اَلْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِي يَأْخُذُونَ اَلْكُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى اَلْمُغِيرَةِ، فَكَانَ يَدُسُّ فِيهَا اَلْكُفْرَ واَلزَّنْدَقَةَ ويُسْنِدُهَا إِلَى أَبِي ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يُثْبِتُوهَا فِي اَلشِّيعَةِ، فَكُلَّمَا كَانَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي مِنَ اَلْغُلُو فَذَاكَ مَا دَسَّهُ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كُتُبِهِمْ<([47]).
وثالثاً: وجود روايات ووقائع من سنخ نفس مضمون الحديث وهو الظواهر والآثار الكونيّة لحديث كربلاء الجليل. وأصحاب البدع يخلطون أقوالهم حقّاً بباطل، وإلا لم تكن الشبهة.
رابعاً: إنَّ كثيراً من الجهات في المقال قابلة للتوسعة والتعميق، إلا أنّ المدى المتاح من وقت وجهد وشروط النشر وحدودها منع من حصول ذلك فعلاً.
خامساً: يقرّ الكاتب تمام الإقرار بالفقر العلميّ وقصور المقال، وكلّ صور النقد العلميّ والفنّي محلّ ترحاب وامتنان.
الخاتمة:
حاول المقال مناقشة طائفة من الروايات تتضمّن بيان حزن البومة على الإمام الحسينg من خلال التأمّل في أسانيدها ومضامينها. وخلص إلى النتائج التالية:
1- الروايات الواردة بهذا المضمون وردت في كامل الزيارات، وكلّها ضعيفة سنداً، ما عدا الأولى التي يتوقّف اعتبارها على توثيق محمد بن عيسى بن عبيد، والحسين بن أبي غندر. وهما موثّقان عند بعض الأعلام، وغير موثّقين عند آخرين.
2- مضمون الروايات المذكورة يتضادّ بوضوح مع معطيات تاريخيّة وعلميّة إنْ لم تشكّل علماً أو اطمئناناً، فإنّ من شأنها أن تمنع من اعتبار هذا المضمون. هذا إضافة إلى أنّ خبر الآحاد لا حجية له في باب الموضوعات، ولا أقل لا يوجب علماً بالقضايا الخبريّة.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين.
([1]) ولا يخفى أنَّ دور غير الماديّ في الماديّ ثابت بالأدلة العقليّة، وفاقاً لما تشير إليه النّصوص.
([2]) لا يُدّعى هنا أنّ الإعجاز خلاف القانون والسنّة التكوينية، بل خلاف ما يسمّى بالقانون الماديّ وما يقع عادة.
([3]) كامل الزيارت، جعفر بن محمد ابن قولويه، ص99، النَّجف الأشرف، المطبعة المبارکة المرتضوية.
([4]) مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج٤، ص١٨٣.
([5]) كامل الزيارت، جعفر بن محمد ابن قولويه، ص99، النَّجف الأشرف، المطبعة المبارکة المرتضوية.
([6]) كامل الزيارت، جعفر بن محمد ابن قولويه، ص99، النَّجف الأشرف، المطبعة المبارکة المرتضوية.
([7]) وهكذا في مدينة المعاجز أيضاً، السيد هاشم البحراني، ج٤، ص١٨٣.
([8]) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج4، ص25.
([9]) كامل الزيارت، جعفر بن محمد ابن قولويه، ص99، النَّجف الأشرف، المطبعة المبارکة المرتضوية.
([10]) رجال الطوسيّ، الشيخ الطوسيّ، ص422.
([11]) رجال النجاشيّ، النجاشيّ، ص234.
([12]) موسوعة الإمام الخوئي، السيد الخوئي، ج7، ص150. قم المقدسة، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
([13]) كما ذهب إلى وثاقته الشيخ الشبيري.
([14]) النجاشي: "كوفي، يروي عن أبيه عن أبي عبد اللهg، ويقال هوعن موسى بن جعفر عليهما السلام. له كتاب". وقال الشيخ: "الحسين بن أبي غندر: له أصل".
([15]) ولعدم قبول السيد الخوئي الكبرى لم يبن على توثيقه كما يبدو، وبنى على توثيقه السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ الشبيري.
([16]) رجال النجاشيّ، النجاشي، ص132.
([17]) الرجال، ابن الغضائريّ، ص66.
([18]) معجم رجال الحديث، ج9، ص148.
([19]) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج20، ص61.
([20]) رجال النجاشيّ، النجاشي، ص204.
([21]) الكافي، الشيخ الكليني، ج٥، ص٥٢٧، دار الحديث.
([22]) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج٧، ص٤٨٥، مؤسسة آل البيت.
([23]) صحيح البخاري، البخاري، ج4، ص252.
([24]) سنن النسائي، النسائي، ج5، ص408.
([25]) مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج4، ص245.
([26]) صحيح ابن حبّان، ابن حبّان، ج7، ص73.
([27]) كامل الزيارت، جعفر بن محمد ابن قولويه، ص81، النَّجف الأشرف، المطبعة المبارکة المرتضوية.
([28]) التوحيد، المفضّل، ص72.
([29]) توحيد مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد، هادي نصيري، ومحمد علي صالحي، مجلة كتاب قيّم، العدد 16، ص133.
([30]) أقدم أحفور يعود للبومة يؤرخ بما يقارب 58 مليون سنة.
([31]) البومة: التاريخ الطبيعيّ والثقافيّ، ديزموند موريس، ترجمة: عزيز صبحي جابر، ص20، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
([32]) البومة: التاريخ الطبيعيّ والثقافيّ، ديزموند موريس، ترجمة: عزيز صبحي جابر، ص29، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
([33]) البومة: التاريخ الطبيعيّ والثقافيّ، ديزموند موريس، ترجمة: عزيز صبحي جابر، ص33، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
([34]) كليلة ودمنة، باب البوم والغربان، ص55.
([35]) الكتاب المقدّس، سفر المزامير، 102 : 6.
([36]) المفصل في تاريخ العرب، جواد علي، ج12، ص373 و367.
([37]) الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري، ج1، ص37.
([38]) الكشكول، الشيخ البهائي العاملي، ج١، ص٢٣٠.
([39]) أدب الكاتب، ابن قتيبة الدينوري، ص7.
([40]) الأغاني، أبي الفرج الأصفهاني، ج٢١، ص١١٦.
([41]) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج4، ص181.
([42]) جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، ج١، ص٤١٥.
([43]) تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ص329.
([44]) مجمل ما سيذكر يمكن لحاظه في المصادر التاليّة:
البومة: التاريخ الطبيعيّ والثقافيّ، ديزموند موريس، ترجمة: عزيز صبحي جابر، ص29، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.
Grzimek's Animal Life Encyclopedia, Grzimek, Bernhard, Volume 9, page 331.
Owls of The World, Claus Konig, Freidhelm Weick.
([45]) انظر:
How Long Do Owls Live? (Owl Lifespans Explained), Retrieve from:
https://avibirds.com/how-long-do-owls-live/
([46]) دروس في وضع الحديث، ناصر رفيعي المحمدي، ص68، دار المصطفى العالميّة.
([47]) اختيار معرفة الرجال، الكشي، ج1، ص225.



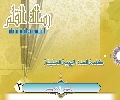






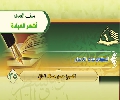

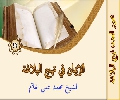


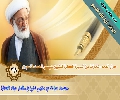

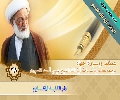


0 التعليق
ارسال التعليق